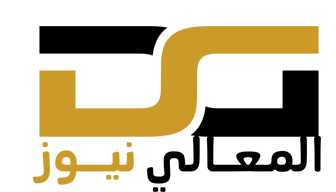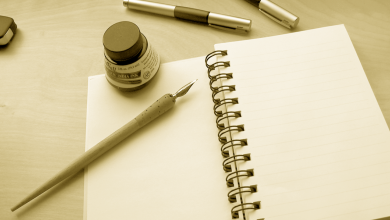البرلمانات ودورها في مكافحة خطاب الكراهية

كتب محمد وليد صالح.. لخطاب الكراهية تأثير ضار في الحوار السياسي واتخاذ القرار، مما يحدّ من قدرة أولئك الذين ينتمون، على وجه الخصوص، إلى الفئات المهمشة على المشاركة العامة، وبالتالي حرمانهم من حقوقهم.
وهذا أيضًا له آثار أوسع على التنمية البشرية، سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية، إذ يُعدّ من معوّقات توفير المساحة والفرصة والقدرة على النجاح لجميع المواطنين. فخطاب الكراهية يُقسِّم ويخلق مناخًا تقلّ فيه احتمالية تحقيق التنمية المستدامة.
ولتحقيق توازن بين الحدّ من الآثار الضارة لخطاب الكراهية، وحق الإنسان الأساسي في حرية التعبير، تمت مناقشة هذا التوازن وإدارته في الأمم المتحدة. وقد تبلور ذلك في المادة (19) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي تم تبنّيها عام 1966، كما حدّدت الاتفاقيات الأخرى معايير النقاش. وبدأ عدد من الوكالات، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، واليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تطوير استجابات لتأثير خطاب الكراهية على التنمية.
وعلى وجه الخصوص، كانت هناك أمثلة في السنوات الأخيرة لبرلمانات طوّرت دورًا إيجابيًا في مكافحة خطاب الكراهية، من خلال مبادرات وفرص جديدة لمشاركة المواطنين، وذلك عن طريق القضاء على التأثير السلبي لهذا الخطاب، والحد من المخاطر التي يسببها. كما تجلّت أدوار متنوعة محتملة يمكن أن تضطلع بها البرلمانات، مع الحاجة إلى مراجعة وتحديد هذه الأدوار لتقدير العمل الذي يمكن أن تقوم به، بدءًا من تحديد التشريعات والأطر التنظيمية، إلى تسهيل المناقشات القائمة على الأدلة.
ينبغي أن يكون دور السلطة التشريعية في مقدمة النقاش حول مكافحة خطاب الكراهية.
وقد شمل مشروع بحثي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحقيق هذه الغاية من خلال تحديد وتعزيز إجراءات محددة من البرلمانات لمكافحة خطاب الكراهية ولغته السامة، والتي قد تُخلّف بوادر لنوع من الإبادة الجماعية. كما سعى المشروع إلى بناء قاعدة معرفية حول هذه العلاقة، والتركيز بشكل خاص على الأدوار والمسؤوليات، في ضوء تعريف خطاب الكراهية بأنه: “أي نوع من التواصل في الكلام أو الكتابة أو السلوك، يهاجم أو يستعمل لغة ازدراء أو تمييزية، بالإشارة إلى شخص أو مجموعة، على أساس هويتهم أو دينهم أو عرقهم أو جنسيتهم أو لونهم أو نسبهم أو نوع جنسهم أو أي عامل هوية آخر”.
ولتأثير الكلام المحرّض على الكراهية موانع عديدة، منها:
• كيف يؤثر خطاب الكراهية على الخطاب السياسي وصنع السياسات؟
• ما هو التحدي الإنمائي الأكثر ارتباطًا بخطاب الكراهية؟
• كيف يؤثر خطاب الكراهية على النساء والأقليات؟
• وما هي نظرية التغيير التي تتيح مسارًا لمعالجة خطاب الكراهية بوصفه تحديًا تنمويًا؟
أما المجتمع المدني ووسائل الإعلام، فتتضح أدوارها من خلال تساؤلات عدة:
•ما هو الدور الذي تلعبه الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووسائل الإعلام في ضمان معالجة البرلمانات لخطاب الكراهية بطريقة شاملة تدعم مشروع التربية الإعلامية الرقمية لحقوق المواطنين وناخبيهم؟
• كيف يمكن للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، إشراك البرلمانيين بشكل فعّال في معالجة خطاب الكراهية؟
• ما هي النُظم التي يجب وضعها لضمان المشاركة الفعّالة؟
• كيف يمكن للمجتمع المدني رعاية بيانات رصد خطاب الكراهية، وتقديمها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، لجعلها مفيدة للبرلمانيين؟
• وكيف يمكن للمجتمع المدني التعامل بشكل فعّال مع البرلمانات لدعم الإصلاح التشريعي لمكافحة خطاب الكراهية؟