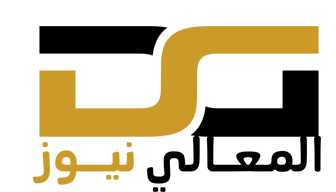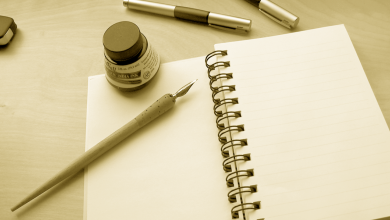كتبت د. جيهان بابان: تواجه مكونات البيئة الثلاثة، الهواء والماء والتربة وجميعها مقومات أساسية لاستمرار الحياة في العراق تحديات خطيرة وخاصة المياه، التي تم تصنيفها من الشح إلى الندرة، حسب أحدث التصريحات الرسمية لوزارة الزراعة العراقية ودعمتها التقارير الدولية، التي تؤكد ضرورة الارتقاء بإدارة الموارد المائية في العراق من سطحية وجوفية، بما يوازي المخاطر المتوقعة والآتية لا محالة، والتعامل معها كأزمة سيادية ووجودية تهدد الأمن الغذائي والوطني وصحة وسلامة العراقيين وخاصة الفئات الهشة منها.
هذا التحول من الشح إلى الندرة هو أكثر من مجرد أزمة بيئية، بل يمتد إلى تقويض الأساس الحضاري الذي كان سمة حضارات بلاد الرافدين تاريخياً والذي جوهره العلاقة البنيوية بين الدولة والمياه ذي البعد الرمزي والتاريخي، وتكمن في قلب الثقافة الشعبية الموروثة، منذ أن شهد بناء أول المستوطنات الزراعية قبل 12000 سنة، بسبب وفرة مياهه وخصوبة أراضيه الرسوبية وتحول إلى أهم سلة غذائية في منطقة الهلال الخصيب جذبت الغزاة والطامعين، كما وثقتها السرديات التاريخية والدينية المرتبطة بنهريه العظيمين دجلة والفرات.
وخلال القرن الأخير تحولت هذه الوفرة تدريجياً إلى شح بفعل عوامل مركبة، تشمل التغيرات المناخية وسياسات دول الجوار المتشاطئة ذات النوايا غير الحسنة تجاه واردات مياه حوضي دجلة والفرات تميزت بإقامة السدود وتحويل مجاري الأنهار وبدون تنسيق أو تشاور مع الجانب العراقي، وإهمال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإقليمية والدولية والمطالبات العراقية المتكررة لتوزيع عادل للثروة المائية، وتقاسم الضرر الناجم عن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، التي تشكو منها بشكل خاص منطقة الهلال الخصيب المهدد بالاندثار.
وفاقم من هذه التحديات أسلوب تعامل الحكومات المتعاقبة مع ملف المياه، التي انشغلت بأزمات سياسية ونزاعات عسكرية وحروب داخلية كانت الذروة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فأهملت تحديث البنى التحتية ومواصلة إدارة الواقع المائي بسياقات ردود الفعل المجزأة قطاعياً، بدلاً من الاستجابة المتكاملة على ضوء فلسفة عصرية يشكل جزءاً هاماً منها تعظيم الموارد وتقليل الهدر وتقييم المخاطر وإدارة الأزمات.
ففي خمسينيات القرن الماضي كان التركيز على إقامة السدود لدرء مخاطر الفيضان وجزئياً إقامة النواظم لتوزيع المياه، وقد شهدت سبعينيات القرن الماضي محاولات جزئية لتحسين البنية التحتية أعاقها اختلاق الأزمات والنزاعات والحروب الإقليمية والدولية، التي خاضها النظام السابق والتي انتهت باحتلال العراق في 2003.
وقد واجهت الحكومات العراقية التي تشكلت بعد انتهاء مجلس الحكم في 2004، تحديات سياسية واقتصادية كبيرة فاقم منها النشاط المتصاعد للمنظمات الإرهابية، التي استخدمت البيئة وأحدها مشاريع المياه أهدافاً لإثارة الرعب كمحاولة تفجير سد الموصل ضاعف منها الفساد والهدر المالي والإداري والمائي وتدني تنفيذ مشاريع تطوير المياه، التي لو أنجزت لوضعت العراق في وضع مائي أفضل.
وتشير الإحصائيات إلى حدوث انخفاض حاد في الخزين المائي عام 2025 إلى ما يقرب من 10 مليارات متر مكعب وهو الأدنى، مقارنة بالسنوات السابقة ولعدة أسباب رئيسة منها الانخفاض الحاد في معدل هطول الأمطار السنوي خاصة في الوسط والجنوب والسياسة المائية غير الصديقة للدول المتشاطئة، التي قلصت واردات العراق المائية التي تمثل شريان العراق الحيوي.
فالواردات من تركيا التي تمثل 70% مما يصل عبر نهري دجلة والفرات، انخفضت بسبب بناء أكثر من 20 سداً وأيضاً من جانب الجارة الشرقية إيران التي تعتمد عليها محافظات ديالى وواسط وميسان بتحويلها أكثر من 35 رافداً خلال العقد الأخير أدت إلى انخفاض الواردات بمعدل 80%، ما شكل تهديداً مباشراً للزراعة والمياه الجوفية وانخفاض منسوب المياه في سد دوكان ودربندخان.
ومما زاد الأمر تعقيداً رفض الجارين المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام الأنهار الدولية غير الملاحية، وبسبب ذلك تضع العراق في موقف تفاوضي أضعف دولياً، على الرغم من أحقيته وتستدعي البحث عن أدوات لتمكين الجانب العراقي مفاوضات سياسية واقتصادية واجتماعية ضاغطة، لأن السمة التفاوضية الغالبة لدى هؤلاء الشركاء الإقليميين هي المماطلة والتسويف (يقدر الخزين المائي المتوقع في ظل سياسة مائية عادلة لتقاسم الضرر بحدود 60 مليار متر مكعب).
ومن المتوقع في حالة استمرار حالة خنق العراق مائياً مع تصاعد درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر وتناقص الأمطار إلى جفاف القسم الجنوبي لنهر الفرات بالكامل، بينما سيصبح نهر دجلة مجرى مائياً محدوداً وتبعات ذلك كارثية على الخطط الزراعية والأمن الغذائي، فسيفقد العراق سنوياً 100 كيلومتر مربع من الأراضي الصالحة للزراعة، بينما يعني ضياع مليار متر مكعب من الماء، وتصحر 260 ألف دونم (هناك فرق بين التصحر الذي يؤدي إلى موت التربة والأحياء الدقيقة من الصحراء، التي تمثل عالماً فريداً من التوازن البيئي بحاجة إلى الإدامة والرعاية).
ومن تبعات اتساع الجفاف والتصحر هو تناقص الثروة الحيوانية بسبب غياب المراعي الخضراء وارتفاع أسعار العلف والتهريب، وإلى تقلص منطقة الأهوار الغنية بالتنوع الثقافي والاحيائي والتي تحتاج إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا لمنع تراجعها.
ومن العوامل المعرقلة للحفاظ على موازنة مائية مستدامة هو الهدر المائي، سواء في الزراعة الذي يستهلك 70% من مجمل الوارد، نتيجة التبخر والاعتماد على طرق الري التقليدية (مع ملاحظة بعض التحسن النسبي مؤخرا في استخدام تقنيات الرش والتنقيط) واستمرار الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، ذات الأهمية الاستراتيجية والهدر في الاستخدام المنزلي بسبب تهالك البنى التحتية وضعف الوعي، وأيضاً التجاوزات على الأنهر والحاجة إلى إدامة السدود لتخزين الاحتياط المائي.
من خلال هذه الصورة القاتمة والمحزنة ليس غريباً أن نرى أنهاراً خاصة في الوسط والجنوب وأهوار العراق تصارع الموت مع هجرة كبيرة للفلاحين، التي تزيد من تريف المدن واتساع العشوائيات فيها نتيجة ندرة المياه يرافقها تصاعد الخصومات والنزاعات الاجتماعية وانتشار الأمراض السارية والمعدية، نتيجة تلوث مياه الشرب إلى مستويات عالية.
وتمتلك وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة في العراق، حشداً من أصحاب الدرجات الخاصة والموظفين والمتعاقدين والأجراء يقدر ببضعة آلاف وخططاً تفصيلية جاهزة تم رسمها بالمشاركة مع جهات أجنبية رصينة ومختصة، ولكن تفتقد الآليات والأدوات التي تسهم في التغلب على العقبات البنيوية، التي تعرقل التنفيذ والعودة إلى السياسات التقليدية التي تتحكم بها ردود الأفعال والتي إذا استمرت مع تدهور الرصيد المائي ستشكل تهديداً لمستقبل الأمن الغذائي، نتيجة تقليص الخطط الزراعية ومنع زراعة محاصيل استراتيجية كالشلب (ومنها العنبر الذي يتميز به العراق) والحنطة.
وتؤكد هذه المتغيرات مجدداً على الحاجة إلى إدارة مركزية فاعلة وفعالة لملف المياه، والذي يتطلب من الحكومة العراقية القادمة نتيجة انتخابات 2025 أن تضع رؤية إطارية مركبة ومتكاملة تعتمد أحدث الدراسات المتوفرة لديها في وزارات المياه والزراعة والبيئة والاستعانة بالتقنيات المتطورة والخبرات الدولية والإقليمية والعراقية داخل العراق وخارجه.
ويأتي في مقدمتها تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ قبل ثلاث سنوات لإقامة مجلس وطني اتحادي للمياه وبإشراف من دولة رئيس مجلس الوزراء، يضم الوزارات ذات العلاقة والحكومات المحلية وحكومة إقليم كردستان، مهمته الإدارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لملف المياه وبشكل علمي وعملي فعال تضمن استجابة سريعة وحلولاً مبتكرة مستدامة وسياسات فعالة لإدارة الأزمات، والجمع بين التخطيط الاستراتيجي وتطوير مهارات القيادة الإدارية والتقنية لدى الكوادر الفنية والإدارية، والاستجابة وتطوير آليات عصرية في التعامل مع العقبات والمعوقات الموروثة والمتراكمة كثقافة من أبرزها البيروقراطية الإدارية وضعف الكفاءة الفنية وتداخل الصلاحيات بين الجهات القطاعية والمركز والحكومات المحلية والهدر المالي، كما وتؤسس لمقاربة تبنى سياقات استباقية تعتمد تقييم المخاطر وتحديث الخطط التفصيلية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية، وتحويلها إلى فرص لتعزيز الإدارة المتكاملة للأمن المائي عبر التعاون الفعال بين وزارات الزراعة والمياه والبيئة، ولتصبح الاستخدامات المختلفة للموارد المائية وحدة واحدة تراعي الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المشتركة المستدامة، وتنقل إدارة المياه من القطاعية إلى التكاملية بنيوياً بما يعزز أطر حوكمتها واستدامتها في سياق العلاقة المترابطة بين الطاقة والمياه والأمن الغذائي كشريان للحياة للأجيال القادمة، وتطوير آليات قانونية داعمة وأدوات تعزز الشفافية مثل بناء المنصات الرقمية، التي تنشر بيانات حول الموارد والاستخدامات المائية، وفي متناول الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
ومن مهمات المجلس دعم ومراقبة جهد الإدارات المحلية والبلديات بالتخصيصات المالية، لتوفير المياه الصالحة للشرب (حسب المعايير المنصوص عليها في اللائحة رقم 417 لعام 1974، لمواصفات مياه الشرب القياسية في العراق، المعدلة عام 2000) خالية من التلوث الكيمياوي والبايولوجي والملحي.
ومن أحد تبعات الزيادة السكانية هو رفع الحاجة إلى مياه الإسالة من 4.8 إلى 6.4 مليار متر مكعب سنوياً عام 2035 التي يهدر نصفها، بسبب قدم وهشاشة البني التحتية والاستخدام السيئ للمياه العذبة مثلاً في عمليات استخراج النفط بمعدل 1.2 -2 برميل من المياه لكل برميل من النفط وهو أحد ملوثات المياه السطحية أو في صناعات السمنت والحديد والكهرباء.
ومن الحلول المعروفة والضرورية لمعالجة هذه الأزمة، هو تحديث البنية التحتية لشبكات مياه الإسالة ونصب وصيانة محطات تحلية المياه خاصة الساحلية في البصرة.
وتلعب معالجة مياه الصرف الزراعي (البزل) دوراً هاماً في السيطرة على الملوحة في أنهار العراق، عبر ربط مشاريع الري بقنوات التصريف التي تنقل التدفقات المسترجعة من الزراعة وعزلها عن إمدادات المياه العذبة بسبب تلوثها الكيمياوي بالأسمدة والمبيدات.
ومن مهمات المجلس رسم سياقات المراشنة وتوزيع المياه بما يتماهى وحاجات التنمية والاقتصاد والزراعة ومعايير العدالة الاجتماعية، وإشراك المجتمعات والمنظمات المحلية في إدارة المياه خاصة في المناطق الريفية، وتأسيس صندوق العدالة المائية، لتمويل مشاريع لتقليل الضرر عن الفئات الهشة والمناطق المتضررة وتطبيق القانون للحد من جرائم التجاوزات كبحيرات الأسماك، وتجريم سلوك معظم المؤسسات الحكومية والصحية، التي تلقى بملوثاتها في الأنهر مباشرة وبدون معالجة، والتي تتراكم من أعالي بغداد وصولاً إلى شط العرب، الذي هو أكثر تلوثاً في العراق.
ولأسباب تراكمية وتاريخية يفتقر القطاع الزراعي الذي يعمل في أغلبه كقطاع خاص إلى التمويل والتدريب، وتوفر أدوات الري الحديث بأسعار مناسبة ومدعومة وإلى خبرات الزراعة الحديثة والذكية.
ويمثل هذا الواقع السلبي فرصة لتحفيز اقتصاديات الزراعة، عبر استيعاب وتمكين الشباب العاطلين والعديد منهم من الخريجين في المناطق الريفية على إقامة مشاريع ريادية زراعية مع توفير الخبرة والدعم والتمويل والتوعية والتدريب، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الارواء والزراعة العمودية والذكية، بما يقلل من الهدر المائي ويحسن من المحاصيل، كماً ونوعاً ترافقها سياقات وطنية لدعم الناتج المحلي.
ومن الأهداف الأخرى تفعيل سياقات تعظيم موارد المياه من المصادر التقليدية وغير التقليدية مثل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وحصاد مياه الأمطار والسيول، وجميعها تعتبر استراتيجيات ثابتة لتعزيز الخزين المائي عالمياً، وفي سياق سياسات فعالة ومنهجية لخزن وتوزيع واستخدام المياه، وفقاً لأولويات التنمية المستدامة والعدالة المجتمعية ومواصلة تأهيل السدود وتحسين تقنيات الخزن ومنع التبخر والتسرب.
وتقع على عاتق المجلس المراجعة الدورية للخطط المائية وتحديثها حسب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، وإصدار تقارير دورية عامة عن حالة المياه في العراق وتنسق مع اللجان المختصة في البرلمان العراقي على تحديث البيئة التشريعية والقانونية والقضائية الداعمة لها.
ومن المؤكد أن الحكومة القادمة بعد انتخابات 2025 ستواجه تحديات كبيرة، والتي يمكن تجاوزها بوقت أقصر باستخدام التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.
الأمر الذي يتطلب استثمارات لتوفير بنية تحتية من تقنيات الحاسوب الفائقة السرعة ومهندسي كتابة الكودات وخوارزميات التعلم العميق والشبكة العصبية، التي تعزز اتخاذ القرارات والتنبؤ والنمذجة والتي تستخدم الأن عالمياً في علوم البيئة والمياه والزراعة والطاقة المتجددة، والتي أشر إليها المركز العراقي الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي انشأ عام 2023.
ولكن تبقى ناقصة بدون وجود قاعدة بيانات تجمع بين الصورة والكتابة والأرقام تعتمد ما تقدمه المصادر المفتوحة وأهمها ما توفره الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية، ولكن تبقى قاصرة وتقود إلى استنتاجات مغلوطة بدون قاعدة بيانات عراقية على الأرض، يتم بناؤها محلياّ من خلال إقامة شبكات ومراكز رصد وبضمنها عبر الاستشعار عن بعد وبالمسيرات في حالة الماء والهواء والتربة والتنوع الاحيائي وغيرها من البيانات الأخرى ذات العلاقة بالطاقة والزراعة تقوم بضخها إلى المركز الوطني للبيانات، وصولاً إلى قاعدة بيانات تتيح استخدام صائب وفاعل لتقنيات الذكاء الاصطناعي وبالتنسيق مع مركز الذكاء الاصطناعي العراقي والجامعات العراقية خاصة ذات الخبرة في الدراسات البحثية والتطبيقية في مثلث الطاقة والمياه والبيئة.
وتوفر استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذا تم إتقانها وتوفير مستلزماتها، ستشكل انعطافه نحو الانتقال الأسرع لمعالجة الواقع المائي والزراعي والبيئي، ولنعمل جميعاً من أجل أمن مائي وبيئي مستدام.
خبيرة في علوم البيئة وهندسة الطاقة المتجددة والتغير المناخي
مُؤسِّسة ورئيسة جمعية البيئة والصحة العراقية في المملكة المتحدة
والمركز العراقي لهندسة الطاقة المتجددة والتغير المناخي